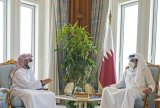![]() حسين ابراهيم
حسين ابراهيم
على غير العادة، لم يغرّد ضاحي خلفان عن لقاء تميم - طحنون، مع أن لا عمل له في هذه الأيام سوى إطلاق التغريدات التي تناول في آخر سلسلة منها كلّ ما يخطر على البال في السياسة، من هجمات كابول الدامية إلى فتح المنافذ البرّية مع سلطنة عمان، ولكن ليس اللقاء بين تميم وطحنون. تجاهلٌ مردّه، على ما يظهر، طبيعة الحركة «الطحنونية» التي تبدو أشبه بتلاوة فعل الندامة، بدءاً من تركيا أمام رجب طيب إردوغان وصولاً إلى قطر. وهو اعتراف قد لا يكون أمام أبو ظبي سواه خياراً، بعدما غلبت الأحداث النظام هناك، وجعلته معزولاً تماماً، جرّاء إخفاق كلّ خياراته التي ثبتت غربتها عن الخليج وشعوبه
منذ تولّي حمد بن خليفة الحُكم في قطر بانقلاب على أبيه عام 1995، شكّلت الإمارات رأس حربة في الهجوم السياسي على الجارة الخليجية؛ إذ سرعان ما استضافت الأب، وساعدته في محاولة لاستعادة السلطة في العام التالي لم يُكتب لها النجاح. كانت الدوحة، في هذا الوقت، قد بدأت تحفر لها تموضعاً دقيقاً مختلفاً عن الدول الخليجية الأخرى، منتهجةً سياسة خارجية وظّفت فيها إمكاناتها المالية الضخمة، من دون أن تمنح شيكاً على بياض لطرف بعينه، ناسجةً علاقات فيها أرجحية دائمة للولايات المتحدة، وأخرى عملية مع إيران، واتصالات مع إسرائيل، قبل أن يفوز رجب طيب إردوغان بالرئاسة التركية عام 2002، ويصبح الحليف الأول للدوحة، بعد واشنطن، ضمن التحالف الداعم لـ«الإخوان المسلمين». هذا التموضع الذي نجح في انتزاع تأثير سياسي للدوحة تتكرّس مفاعليه اليوم بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد قطر ولقائه أميرها تميم بن حمد، لتكون الإمارات بذلك قد أقرّت بفشل المشروع الذي تنتمي إليه والذي بلغت شراسته مداها في السنوات الأخيرة، عندما فرضت أبو ظبي مع الرياض والمنامة والقاهرة مقاطعة رباعية على الدوحة.
كانت الإمارات تطمح إلى تحويل موقعها الاقتصادي كمركز تجاري عالمي إلى موقع سياسي، فانتهجت لتحقيق هذا الهدف خيارات متطرّفة ضمن مشروع أميركي متكامل للشرق الأوسط، شمل «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية، وجَعْل إسرائيل محوراً للأمن الإقليمي، مقابل ضمان بقاء الأنظمة. وهو مشروع اتّضح أنه غير قابل للحياة، ولا قبول له في الخليج، ليتساقط المشاركون فيه من دول وأشخاص، واحداً تلو الآخر، وتبقى الإمارات التي نقلت رهانها بالكامل إلى تحالف ثنائي مع إسرائيل، في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يسقط هذا الرهان أيضاً مع إطاحة الأخير، نتيجة تغيّر موازين القوى عند العدو نفسه. انتكاساتٌ متتالية سيكون للاعتراف الإماراتي بها صدى عميق يتردّد لدى «إخوان الدولة»، المُوزَّعين بين سجون البلد والمنافي في تركيا والغرب، بسبب شدّة التعامل معهم من قِبَل السلطات الإماراتية التي تَعتبرهم الخطر الأول على النظام. وعلى رغم أن قطر لم تكن تسمح لمعارضين إماراتيين بالقيام بأيّ نشاط سياسي انطلاقاً من أراضيها، إلّا أنها أيضاً لم تقبل طلبات أبو ظبي بتسليم معارضين لجأوا إليها في طريقهم إلى المنفى، مثل الناشطة الراحلة آلاء الصديق التي توفّيت في حادث سير في لندن قبل أسابيع، وأعيد جثمانها ليُدفن في قطر، حيث كانت قد أقامت سنوات قليلة، ورفض الأمير مرّتَين طلب محمد بن زايد تسليمه إياها.
اعتراف أبو ظبي بالفشل سيتردّد صداه لدى المعارضة «الإخوانية» الإماراتية الموزَّعة بين السجون والمنافي
لكن، هل يعني التراجع أن النظام الإماراتي تَغيّر، ولن يعود إلى التآمر بعد الآن؟ وهل يعني ابتعاداً إماراتياً عن إسرائيل التي بلغت معها العلاقات قمّة الودّية من جانب حكام أبو ظبي، وطحنون بالذات، قبل أن تخبو؟ الملفّات العالقة بين أبو ظبي والدوحة كثيرة، والزيارة مجرّد بداية متأخرة. فمنذ إعلان المصالحة الخليجية في «قمّة العلا»، في كانون الثاني الماضي، لم تشهد العلاقات بين العاصمتين تسارعاً في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وانعكس توتراً بين الرياض وأبو ظبي. وهذا التوتر بدوره مثّل عاملاً حاسماً في تفاقم العزلة الإماراتية، وبالتالي كان أحد دوافع زيارة طحنون قطر، وقبلها تركيا، حيث تخشى أبو ظبي من تقارب قطري ـــ سعودي ـــ تركي يستهدفها. على الأرجح، لن ينسى القطريون بسهولة ما فعلته الإمارات (ودول المقاطعة الأخرى) في عام 2017، حين طردت كلّ مواطنيها من أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر، وفرّقت بين الزوج وزوجته. ولولا أن سارعت إيران وتركيا إلى تأمين البديل، ووفّرت أجواء الأولى المتنفّس الوحيد للسفر من قطر وإليها، بعد إغلاق الأجواء كلّها أمام حركة الطيران القطرية، لأمكن لدول الحصار خنْق الدوحة وإخضاعها، بذريعة منع التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، من خلال التحالف مع «الإخوان المسلمين» وإيواء قادتهم، والقيام بحملات إعلامية ضدّ هذه البلدان عبر قناة «الجزيرة».
الهاجس الأول للإمارات يبقى حماية النظام. وتأتي حركة طحنون استباقاً لأيّ ارتدادات لفشل المشروع الإماراتي الأصلي الذي خلق لنظام أبو ظبي أعداء كثراً، ما يجعله حُكماً في مهداف مريدي الانتقام، فيما هو بلا حماية. إذ أخطأ هذا النظام الحساب، حين ظنّ أن الغرب (بعيداً عن شطحات دونالد ترامب) ما زال يحتاج إلى وكلاء من نوع الأنظمة التسلّطية نفسها التي كان يتعامل معها طوال العقود الثمانية الماضية، والتي ثبت له أنها ورّطته في مشكلات لم يكن يحتاج إليها، لمصالحها الخاصة، على رغم أنها أمّنت له السيطرة على موارد هذه المنطقة الغنية والمهمّة من العالم. باختصار، الغرب على عتبة الخروج عسكرياً من الشرق الأوسط، وهو محتاج إلى ترتيبات أكثر استقراراً تضمن مصالحه، لا تستطيع الأنظمة القديمة تلبيتها. أمّا حركة طحنون فتؤكّد الانعطافة الإماراتية التي ظهرت أوّلاً في زيارته تركيا، بحيث بات يمكن الحديث عن صفقة سياسية محتملة، تشمل تخلّي الإمارات عن مشاريعها، على الأقلّ تلك التي تستهدف قطر وتركيا مباشرة، فضلاً عن استثمارات إماراتية في تركيا، تعويضاً عن الإساءات التي تسبّبت بها أبو ظبي لأنقرة، وخاصة دعم الانقلاب الفاشل ضدّ الرئيس التركي في عام 2016.
* اختبار ما بعد أفغانستان | ابن سلمان لواشنطن: موسكو تنتظرنا
للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مقولة مشهورة أتى بها قبل وقت طويل من سقوطه، وهي أن “المتغطّي بالأميركان عريان”. قد يكون السعوديون في السنوات الأخيرة، أكثر مَن اختبر هذه المقولة. وفي ظلّ المتغيّر الكبير المتمثّل في الهروب الأميركي من أفغانستان، ربّما أراد محمد بن سلمان تجربة مدى استعداد واشنطن للدفاع عن النظام السعودي في وجه المخاطر الداخلية والخارجية، وفي الوقت نفسه محاولة استغلال هذه الفوضى لتحقيق هدفه الدائم في نيل مباركة أميركية لاعتلائه العرش، فأرسل شقيقه خالد نائب وزير الدفاع إلى موسكو لتوقيع اتّفاق تعاون عسكري مع الروس، يُنظر إليه على أنه تلويح لأميركا بوجود بدائل لديه
عندما خرج السوفيات من أفغانستان في عام 1989، احتفلت السعودية بانتصار الحلف الأميركي عليهم. وكان لها “الحق” في أن تفعل، لما كان لها من مساهمة حاسمة في ذلك، عبر إرسال “المجاهدين” وتمويل الحرب. الآن، وبعد أن دارت الدورة على الأميركي ليهرب هو نفسه من البلد الطارد للغزاة بطبيعته، على حدّ وصف جو بايدن، يمّمت الرياض وجهها مجدّداً شطر موسكو، لتستنجد بعدوّها القديم، وتُوقّع معه اتفاق تعاون عسكري، تعمّد الجانبان عدم الإعلان عن تفاصيله.
منذ زمن، قرّرت الرياض إقامة علاقة صداقة مع موسكو وغيرها، مِمّن كانت تعتبرهم في الماضي أعداء، أو كانت مجبرة على ذلك، بعد حرب أفغانستان في الثمانينيات وغيرها من الحروب المموَّلة سعودياً على السوفيات ثمّ الروس، بما فيها حرب الشيشان. وتزامن التوجّه السعودي الجديد مع تراجع تدريجي في الاهتمام الأميركي بالسعودية. لكن تلك العلاقة ظلّت محدودة وذات وظائف معينة، أهمّها التلويح للأميركيين بوجود بدائل، على رغم إدراك الرياض سلفاً أن طبيعة ارتهانها للأميركي تجعل القرار بيده تماماً. كما كان من بين الوظائف المذكورة تعويض النقص في مشتريات السلاح بسبب سياسات غربية صارت تفرض حظراً جزئياً أو كلّياً على بيع السلاح للمملكة، من قِبَل دول ككندا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. لكن تعويض نقص السلاح نفسه يواجه خطوطاً حمراء أميركية، فعلى رغم إعداد صفقة لشراء منظومات صواريخ أرض - جو “أس - 400” في عام 2018 بين السعودية وروسيا، إلا أنه لم يُسمع عنها شيء مذّاك، بالنظر إلى ما تثيره الصواريخ المذكورة من حساسية خاصة لدى الأميركيين بتبعاتها الخطيرة على مبيعات صواريخ “الباتريوت” والطائرات الحربية الأميركية.
وعليه، ليس من المتوقّع أن تَخرج أيّ مشتريات أسلحة روسية محتملة من جانب السعودية عن السقف الأميركي، على رغم أن العلاقات السعودية - الأميركية هي حالياً في واحد من أدنى مستوياتها التاريخية. لو كان الأمر عائداً إلى السعوديين لأوجدوا بدائل للحماية الأميركية أو متمّمات لها، أمس قبل اليوم. لكن أميركا تُمسك برقاب القائمين على النظام السعودي، ولن تدعهم يذهبون إلى أيّ مكان، حتى لو أرادت الانسحاب عسكرياً من الخليج. فالعلاقة بنيوية إلى درجة يكاد التحلّل منها يكون مستحيلاً. والسلاح السعودي، مثلاً، أميركي بنسبة تزيد عن ثمانين في المئة، وأيّ محاولة حقيقية لتنويع مصادره ستُعتبر لعباً بالنار. وإذا حصلت، فستكون جزئية ومحدودة. إلّا أنه مع ذلك، ثمّة مخاوف أميركية من استغلال روسيا والصين أيّ ثغرة للحصول على قطعة أكبر من كعكة صفقات السلاح.
لو كان الأمر عائداً إلى السعوديين لأوجدوا بدائل للحماية الأميركية أو متمّمات لها، أمس قبل اليوم
مشكلة ابن سلمان أنه ما زال يدور في الحلقة نفسها، منذ تولّي جو بايدن الرئاسة. هو يريد الاطمئنان إلى أن إدارة بايدن ستَقبل به ملكاً، فيما هي ترفض حتى إسقاط القضايا القانونية التي تطاوله في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشهد تطورات في الأسابيع المقبلة، مِن مِثل أن يضاف إليها الكشف عن وثائق 11 أيلول التي تُورّط الرياض في هجمات نيويورك وواشنطن في عام 2001، مع خطر تدفيع المملكة تعويضات ضخمة لأسر 3000 قتيل. يدرك ولي العهد أن أميركا لا تمتنع فقط حتى الآن عن دعمه شخصياً، وإنما أيضاً قد لا تكون جاهزة للدفاع عن النظام كلّه، خاصة في مواجهة تهديدات داخلية، حتى لو كانت مفتوحة على تهديدات خارجية، كتهديد حركة “الإخوان المسلمين”، أو تهديد معارضين من داخل الأسرة المالكة لولي العهد الذي صعد إلى السلطة بدعم من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ثمّ وجد نفسه بعد خسارة الأخير الانتخابات أمام حقائق جديدة غير مريحة تتمثّل في بيئة أميركية معادية للممكلة، وله شخصياً، لا تنفكّ تزداد عداءً منذ هجمات 11 أيلول.
الكلام عن “التنويع” حضر في مقابلة ابن سلمان التلفزيونية الأخيرة في نيسان الماضي، والتي قال خلالها إن الولايات المتحدة لم تَعُد بالقوة التي كانت عليها سابقاً، وإن قوتها تعود جزئياً إلى المال السعودي الذي حصلت عليه عبر السنين. وعلى رغم أنه ليس من الواقعي انتظار أن تزداد كثيراً حصّة الروس أو الصينيين من العلاقات العسكرية مع السعودية، فإن للمملكة مصالح كبيرة مع كلّ من موسكو وبكين، من بين أهمّها أنها تستطيع بالاتفاق مع روسيا التحكّم بأسعار النفط، بوصفهما من أكبر المنتجين له في العالم، في حين أن الصين صارت تنافس أميركا في كلّ الأسواق، بما فيها الخليجية. أمّا حكاية الدفاع عن النظام السعودي أو عن ابن سلمان من تهديدات من داخل النظام، فهي مسألة تخصّ الأميركيين وحدهم، وليس مطروحاً أن يدخل عليها أيّ طرف آخر، إلّا إسرائيل، وبموافقة أميركية وسعودية. وإذا كان الأميركيون يريدون حقاً تنفيذ انسحاب ما من الشرق الأوسط يترك فراغات أمنية، فالأمر سيتوقّف على شكل الانسحاب وحجمه والترتيبات التي سترافقه، مِن مِثل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي ربّما يسمح بترتيبات تشمل العلاقات بين دول المنطقة. ما هو أكيد أن الأميركيين يريدون التخفّف من الكثير من الأعباء المكلفة، مِن مِثل حماية هذا النظام أو ذاك.
كان يمكن للإفصاح عن ماهية الاتفاق السعودي مع الروس في شأن نوعية الأسلحة المشمولة فيه وثمنها والمعاهدات الأمنية المرافقة له - إذا ما وجدت -، أن يجيب على الكثير من الأسئلة. لكن الإعلان عن الاتفاق، بحدّ ذاته، في هذا التوقيت، لا يمكن إلا أن يكون رسالة إلى الأميركيين، بهدف تحريك الملفّات العالقة معهم، خاصة أن خالد بن سلمان نفسه كان قد قام بزيارة لواشنطن في الأسبوع الأول من تموز الماضي، اعتُبرت في حينه “بدلاً من ضائع” لزيارة ولي العهد غير المرغوب به في البيت الأبيض، فيما بدا أنها لم تنجز الكثير. وسواءً كانت ثمّة رغبة حقيقية في تنويع العلاقات أو مجرّد نيّة توجيه تحذير إلى الأميركيين، فإن محمد بن سلمان يستفيد من كون الولايات المتحدة، بدورها، صارت بلداً مكروهاً من قِبَل غالبية السعوديين. وهذا ما أظهرته حفاوة سعوديين كثر على وسائل التواصل الاجتماعي بالاتفاق السعودي - الروسي، باعتبار أن “العالم يتّجه شرقاً”، على حدّ وصف أحدهم.
يبقى البازار السعودي، في كلّ الأحوال، مفتوحاً أمام تحالفات جديدة على الطريقة التي لا يعرف الخليجيون غيرها، وهي شراء الحماية بالمال.