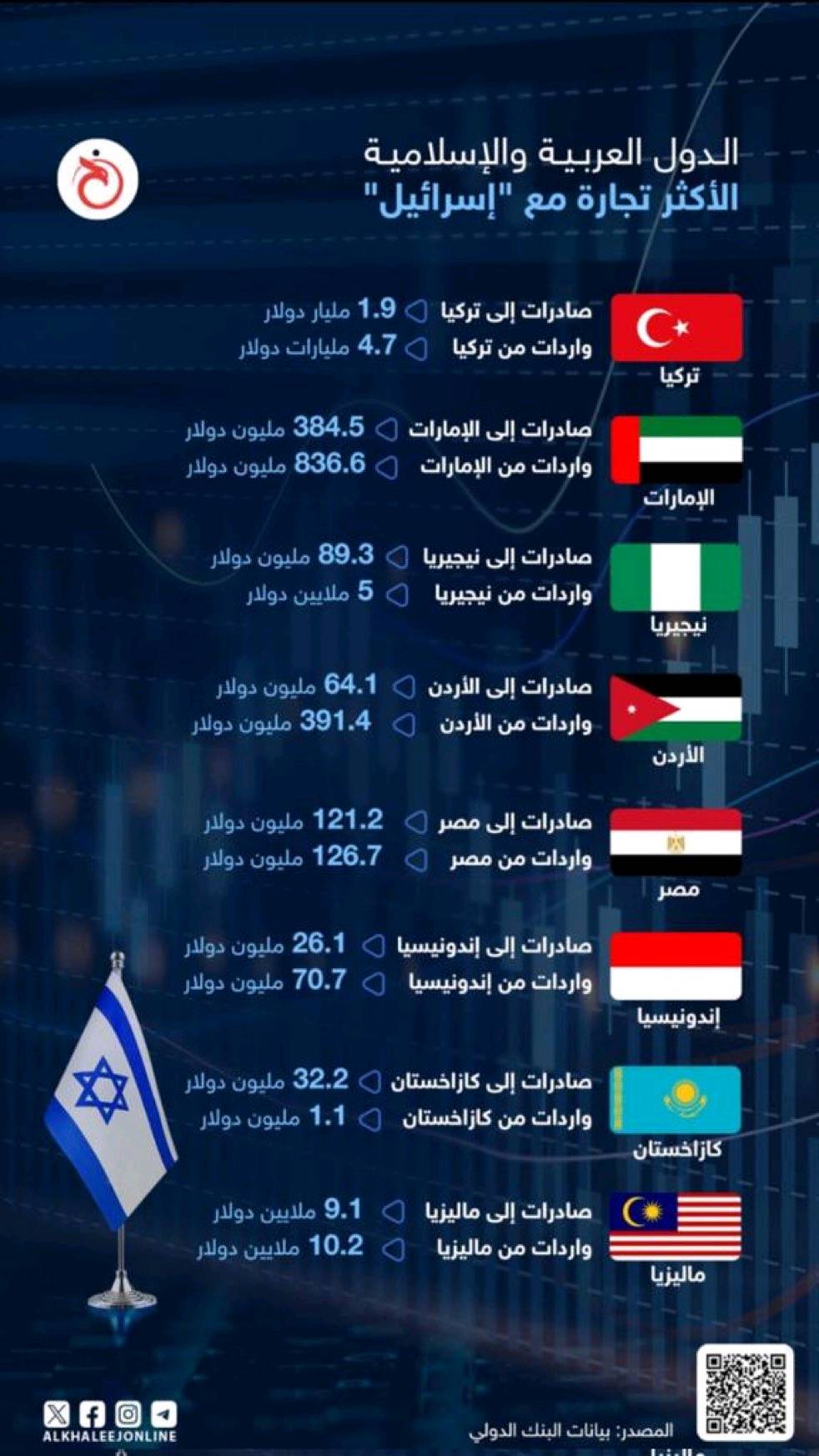في عام 2011، نفر اللاجئون الفلسطينيون في مسيرات العودة التي خرجت من مخيمات اللجوء في غزة والضفة ولبنان وسوريا والأردن، ووصلت إلى أقرب نقطة من حدود فلسطين المحتلة عام 48، ونجح عدد من المتظاهرين فعلاً في اختراق الحدود في مجدل شمس بالجولان والدخول إلى الأراضي المحتلة، محققين بذلك نصراً رمزياً.
كانت مسيرات العودة في ذلك العام جريئةً ونوعيةً، وأحيت حق العودة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول الصحيح، محرِّرةً إياها من متاهات التجزئة والتصغير. صحيح أن الإنجاز الذي تحقق كان رمزياً، وأن الخطوة لم تتبع بخطوات، لكن مرد ذلك أن قرار مسيرات العودة لم يكن قراراً وطنياً استراتيجياً ينفذ عبر فعل جمعي تراكمي، بل كان حراكاً عفوياً قادته مجموعة من الشباب، وكانت ساحة التحشيد الرئيسة له مواقع التواصل الاجتماعي، دون إسناد كبير من القوى الفلسطينية المهيمنة. لذلك، لم يؤسس على تلك الخطوة، لكن الفائدة الأهم لتلك المسيرات كانت أنها نبهت إلى أسلوب نضالي جديد يمكن، لو فكر الفلسطينيون فيه بشكل جاد، أن يمثل ورقة قوة مهمةً تربك دولة الاحتلال وتستنزفها في ميدان لا تحسن المواجهة فيه.. إنه ميدان القوة الناعمة الذي لا يقاتل الشعب المستضعف فيه بقوة السلاح، إنما بقوة الديموغرافيا وقوة الإيمان بالحق. وهو قادر بهذه المعطيات، إن امتلك الإرادة والوعي، أن يزعج المشروع الإحلالي الصهيوني، عبر تهديد الأساس الذي أقام مشروعه عليه في فلسطين، وهو ضمان استمرار التفوق الديموغرافي داخل حدود دولته.
حلم
لك أن تغمض عينيك، وتتخيل مشهد اقتحام مليون لاجئ فلسطيني للحدود، واعتصامهم سلمياً داخل الأرض المحتلة التي هجروا منها قبل 70 عاماً، وإصرارهم على عدم المغادرة. ماذا بوسع الترسانة النووية والصاروخية الصهيونية أن تفعل لمواجهتهم؟
هذا الخيار في عام 2018 يبدو اضطراراً، خاصة في حالة غزة، المثال النموذجي للقهر والبؤس الذي يدفعه الفلسطينيون ثمناً لاستمرار مأساتهم التاريخية
إذا كان التفكير في مسيرات العودة في عام 2011 اختياراً يملك الفلسطينيون إزاءه شيئاً من رفاهية التأجيل والتأني، فإن العودة إلى هذا الخيار في عام 2018 يبدو اضطراراً، خاصة في حالة غزة، المثال النموذجي للقهر والبؤس الذي يدفعه الفلسطينيون ثمناً لاستمرار مأساتهم التاريخية.
ثمة عديد من المؤشرات المقلقة حول مخطط يحاك للقضية الفلسطينية عموماً، ولغزة خصوصاً، من قبل دولة الاحتلال وأمريكا والأنظمة العربية. فقبل حوالي شهر، أعلن ترامب عن القدس عاصمةً لدولة الاحتلال، ثم صادق حزب الليكود على ضم أراضي الضفة لدولة الاحتلال. ويبدو أن أحد بنود صفقة القرن التي يباركها ترامب وأنظمة عربية بقوة؛ يتضمن توسيع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهذا ما يؤكده الواقع الميداني في سيناء التي تشهد مسارعةً في عمليات تهجير سكانها دون أسباب أمنية مقنعة، وزاده تأكيداً تسريب صحيفة نيويورك تايمز الذي كشف عن تعليمات للإعلاميين المصريين بالتحريض على إخلاء سيناء من المدنيين. أضف إلى ذلك تحذير أردوغان الأخير بأنه يجري الآن نقل مقاتلي داعش من الرقة السورية إلى سيناء المصرية؛ لاستعمالهم في ضرب أهداف جديدة بعد انتهاء دورها في سوريا. وبعد تحذير أردوغان بأيام، أصدرت ولاية سيناء فيديو لإعدام مواطن سيناوي بتهمة دعم حركة حماس، وظهر في الفيديو أربعة مسلحين، جميعهم من قطاع غزة، وكأن المقصود بهذا الفيديو تعميق الأجواء العدائية بين حركة حماس في قطاع غزة وتنظيم الدولة في سيناء؛ لجر حركة حماس إلى فخ سيناء، وتحويل قبلة الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، وبذلك تنضج اللحظة التاريخية لفرض تسوية إقليمية تضيع الحقوق الفلسطينية.
إنه ميدان القوة الناعمة الذي لا يقاتل الشعب المستضعف فيه بقوة السلاح، إنما بقوة الديموغرافيا وقوة الإيمان بالحق. وهو قادر على أن يزعج المشروع الإحلالي الصهيوني
في هذه الأثناء يتعرض قطاع غزة للحلقة الأشد من الحصار، فقيادة السلطة عادت عبر بوابة المصالحة إلى غزة للسيطرة على الجباية والضرائب، ثم تنكرت لمسؤولياتها ولحقوق الموظفين، وهو ما تسبب بتفاقم المعاناة الإنسانية. فهناك شح في الدواء ولوازم المستشفيات، وهناك عشرات آلاف الموظفين لا يجد أحدهم في جيبه ثمن الخبز لإطعام أطفاله. بل إن محمود عباس، وفي سعيه لسد كل منافذ الحياة على غزة، عمد إلى فرض ضريبة على الوقود المصري الذي كان يباع بسعر أقل من الوقود الإسرائيلي، ليساويه بثمن الوقود الإسرائيلي، وبذلك طال الشلل الكامل كافة مرافق الحياة في القطاع.
ولتكتمل فصول العجز والقهر فإن الواقع الدولي والإقليمي يمنح دولة الاحتلال غطاءً إذا شنت حرباً عسكرية على غزة أن تعمل فيها تقتيلاً وتدميراً دون أن يكون هناك سند وظهير للقطاع. إن حال غزة الآن يشبه حال الجيش الذي خاطبه قائده قائلاً: العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، ولا خيار أمام غزة إلا أن تواجه قدرها بشجاعة وأن تبحث في أي ثغرة في الحصار المحكم عليها لتقليل الخسائر.
إن غزة لم تعد تملك حتى خيار الانتظار؛ لأن مأساة الناس فيها، ونقص الرواتب والدواء وضرورات الحياة؛ تفوق الاحتمال
إن غزة لم تعد تملك حتى خيار الانتظار؛ لأن مأساة الناس فيها، ونقص الرواتب والدواء وضرورات الحياة؛ تفوق الاحتمال، والانتظار يعني إنضاج المخططات المعادية وإعطاءها الفرصة لتوجيه ضربتها القاضية إلى القطاع. أما خيار المبادرة إلى استجلاب مواجهة عسكرية مع الاحتلال، في ضوء المعادلة السياسية المختلة، وفي ظل إحكام حصار غزة، فهو أبعد ما يكون عن الحكمة. وفي ظل هذه القيود محكمة الوثاق، لا يبدو أمام الفلسطينيين من غزة إلا خيار النفير إلى الشمال؛ هروباً من مخطط الاستدراج إلى الجنوب.
كسر الحصار
ماذا لو خرج مائتا ألف متظاهر في مسيرة سلمية، وتوجهوا إلى السلك الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 48، ونصبوا الخيام، وأقامت فيها العائلات من كبار السن والنساء والأطفال، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً يشهده الإعلام العالمي، ووجهوا من هناك نداءاتهم إلى الأمم المتحدة؛ بأنّ غزة تموت، وأن هؤلاء اللاجئين مسؤوليتها، وأنهم لا ينوون العودة إلى قطاع غزة الفاقد لشروط الإقامة الآدمية، وأن بقاء ظروف الموت البطيء ستضطر هؤلاء اللاجئين إلى اقتحام الحدود لأنه لم يعد لديهم ما يخسرونه، ولأن اقتحام الحدود سلمياً هو حقهم الأخلاقي والقانوني، فقرار الأمم المتحدة 194 ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم؟
إن الفصائل تحشد في أيام انطلاقاتها مثل هذا العدد وتنفق على إقامة المهرجانات مئات آلاف الدولارات، ثم تنفض الجموع بعد ساعات دون هدف، فماذا سيضير هذه الفصائل مضافاً إليها مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لمواجهة الموت البطيء الذي تتعرض له غزة وأن تقرر نقل الأزمة إلى حدود العدو ودعوة الجماهير أن تعسكر في الخيام وتعلن اعتصاماً مفتوحاً وترفع أعلام فلسطين وقرار 194؟
اعتصام مئات الألوف بالقرب من الحدود سيسلط أضواء الإعلام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على مأساة هؤلاء اللاجئين
هذه الخطوة ستمثل إرباكاً حقيقياً للعدو، وستنقل الفلسطينيين في غزة من حالة انتظار الموت السلبية إلى محاولة الفرار من الموت. فاعتصام مئات الألوف بالقرب من الحدود سيسلط أضواء الإعلام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على مأساة هؤلاء اللاجئين، بل ينبغي مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الشروط اللوجستية للاعتصام من طعام وشراب وخيام. كذلك، فإنه سيستنفر دولة الاحتلال لأنها ستظل قلقةً من اختراق هؤلاء المعتصمين في أي لحظة السياج الفاصل، كذلك فإنها ستشجع اللاجئين في المناطق الأخرى، مثل الضفة ولبنان، إلى المبادرة إلى الحشد والاعتصام على الحدود.
إن المأمول من هذه الخطوة هو العودة الفعلية إلى فلسطين. فالجماهير الكبيرة قادرة إذا امتلكت الإرادة والإصرار على اختراق الحدود، لكن حتى لو لم يتحقق هدف العودة قريباً، فإن مشهد الاعتصام المفتوح على بعد مئات الأمتار من الحدود سينجح مرحلياً على الأقل في رفع مستوى الرعب الإسرائيلي، وهو ما قد يفضي إلى إحداث تصدع في جدار الحصار وإلى إرسال رسالة قوية لمن يعنيه الأمر بأن وجهة غزة لن تكون سيناء بل الداخل المحتل، كذلك فإن هذا الاعتصام سيبني مخيالاً شعبياً عاماً يرى السياج الفاصلة مع أراضيه المحتلة برؤية جديدة مفعمة بالأمل، فيرى فيها طريق العودة بعد أن كان يرى فيها حاجزاً منيعاً يبعده عن الوطن.
مشهد الاعتصام المفتوح على بعد مئات الأمتار من الحدود سينجح مرحلياً على الأقل في رفع مستوى الرعب الإسرائيلي
واقعية؟
هناك من يسخر من هذه الفكرة، لكن الناس كثيراً ما يسخرون من الأفكار لأنها جديدة على مألوفاتهم، وليس لعلة في مضمونها. هؤلاء الساخرون يقعون في تناقض صارخ، فهم لا يجدون حرجاً في مقتل ألفي إنسان في حرب لم نجن منها ثمرةً سياسيةً، لكنهم يدَّعون شفقتهم من احتمال مقتل عشرين أو ثلاثين إنساناً في خطوة كبرى مثل هذه يبدو أثرها فاعلاً.
لهؤلاء الساخرين أقول:
الدعوة في المرحلة الأولى ليست إلى اقتحام الحدود؛ لأن سقوط ضحايا منذ البداية قد يضر بالفكرة، والاعتصام السلمي بعيداً عن الحدود بنصف كيلومتر يمكن أن يحقق كثيراً من الأهداف السياسية والإعلامية والتحشيدية، ويبقى الناس في منطقة آمنة.
ثانياً، فإننا لسنا في رفاهية اختيار، إننا نموت في مكاننا الضيق المحاصر، فلماذا لا ننفر قبل أن تذبحنا السكين؟
إنهم يدبرون المكيدة لطردنا إلى الجنوب، بعد أن يعملوا فينا قتلاً، فلماذا لا نسبقهم بخطوة ونبادر بالفرار إلى الشمال؟
إن كان لا بد من ثمن، فليكن هذا الثمن في الاتجاه الصحيح، اتجاه العودة إلى فلسطين، اتجاه أن نكسب أرضاً جديدةً، وأن نعمق مأزق العدو الوجودي..
إننا نموت ونحن قاعدون في ديارنا، وإسرائيل آمنة مطمئنة، فلماذا لا نزعجهم ونجبرهم على دفع ثمن لموتنا؟
أليس الموت أثناء محاولة الفرار خيراً من الموت وأنت مستكين لسكين الجزار؟
"إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً".
"ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون".